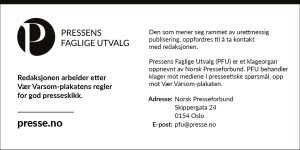صوت النرويج 11 نوفمبر 2008/اوسلومالمدينة المنورة/ سيبقى العلم قاصراً عن إدراك الكثير من المعاني والإشارات العلمية في القرآن الكريم، لا لشيء إلاَّ ليستمرَّ التحدي الإلهي قائماً، تُكْتَشَفُ أَسرارُها الباهرةُ التي لا تنفد شيئاً فشيئاً إلى قيام الساعة، ومهما توصَّل الإنسانُ إلى نظريات علمية تُعارِضُ في ظاهرها نَصّاً قرآنياً، فَسَيَثْبُتُ في النهاية بُطلانُ النظرية أو نَقْصُها، ومن هنا وقف المفسرون موقفاً حَذِراً من محاولة رَبْط كلِّ نظرية علمية حديثة بالنصوص القرآنية، لأن النظرياتِ العلميةَ قابلةٌ لِلنَّسْفِ والنقد والتغير، والنصوص القرآنية ثابتة أصيلة، وبعضُ مَن وقع في مثل هذا الرَّبْط إمّا فاتَهُ بُعْدُ النَّصِّ وَعُمقُه، فحاوَلَ لَوْيَ عُنقِ النَّصِّ ليتوافَقَ مع النظرية، أو لم تُكتَبْ له الحياةُ في زمان العلم المُمَهِّد لفهم النَّص، فجاء تفسيرُه بعيداً عن جَوِّ النَّص الروحي أو العلمي أو التشريعي.
وفي عصرنا الحديث الذي شَهِدَ أكبرَ نهضة علميةٍ في التاريخ، تتجلَّى لنا في كل يوم جوانبُ إعجازيةٌ في القرآن الكريم وصحيح السُّنة، تبهر العقول، وَتُحَيِّر الأفهام، ويزداد بها الذين آمنوا إيماناً، ولا يملك المعاندون أمامها إلاَّ أن يقفوا ويتريثوا ملياً، تلجمهم الحيرة، وتعقد ألسنتهم الدهشة، فمنهم مَن لا يترَدَّدُ – أمامَ البراهين الساطعة – إلاَّ أن يعلنها صريحةً مدوِّية: لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله، ومنهم مَن يُكابر ويُعاند، فلا يزيد على أن يُبدِيَ إعجابه بـ “عبقرية” محمد صلى الله عليه وسلم!.
“المُعَرَّب” في القرآن الكريم :
يَقصد علماءُ اللغة بِالمُعَرَّب – بشكل عام – ما لَحِقَ باللغة العربية من مفرداتٍ أعجمية باتتْ – مع الوقت – من صميم العربية.
وليس هذا محلّ خلاف بين العلماء، فهو ضرورةٌ حضارية لازمة، وهو أيضاً ظاهرٌ في مفردات عربية كثيرة، خاصة ما لَحِقَ بالعربية منها بعد الفتوح الإسلامية.
أما خلاف علماء التفسير واللغة ففيما وقع في القرآن الكريم منها، رغم القَطْع الرَّباني بأنه “لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ” النحل(103) و”إِنَّا أَنزَلنَاهُ قُرآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ” يوسف(2).
فالعلماء من هذا الوقوع على فريقين:
1- فريق ينكره أشدَّ الإنكار، ويأباه أعظمَ الإباء، ويرى أن هذا القول يطعن في القرآن ذاته.
2- وفريق يقول بوجوده، ويرى أن هذه المفردات هي من اللغات الأعجمية التي شاع استعمالُها بين العرب، وَجَرَتْ بها ألسنتُهم، وانصهرتْ في بوتقة لغتهم، بعد أن اتَّخَذَتْ شكلاً يُوافِقُ الصوتَ والبنية والوزن والهيئة العربية، وأن هذا الاقتباسَ من اللغات المُجاورة جزءٌ من الضرورات التاريخية والحضارية يؤدي إلى احتكاك اللغات بعضها ببعض، والتأثُّر والتأثير فيما بينها.
ولكنَّ الذي غاب عن علمائنا الأقدمين معذورين، ولم يُشِرْ إليه – غالباً – علماؤنا المعاصِرون مُؤاخَذين، هو الصِّلة الوثيقة بين هذه المفردات واللغات السامية (الجَزَرية)، وكون العربية أُمّ هذه اللغات وأساسها، فهذه المفردات إذاً أَصيلَةٌ في العربية لا هَجِينة، وهي بالتالي صادِرَةٌ منها إلى تلك اللغات، لا واردةٌ إليها منها.
ويبدو أن علماءنا الأقدمين لعدم توصُّلهم إلى معرفة الرابطة السامية بين مجموعة اللغات للأمم المحيطة بالعرب، كانوا لا يتوانون عن القول بتعريب مفردةٍ قرآنية لها نظيرتُها في اللفظ والمعنى في لغة سامية أخرى، لِشُعورهم بفضل تلك الأمم عليهم في العلم والحضارة، فهي بالتالي مُؤَثِّرةٌ فيهم لا متأثرة، فإذا ما توافَقَتْ مفردةٌ قرآنية بأخرى سامية كالعبرية والسريانية مثلاً، فهي – في ضوء هذا الشعور – مُنتقِلَةٌ من تلك اللغات إلى العربية، لا العكس.
علم اللغات السَّامِيَّة (الجَزَرية) :
هذا التشابه بين مفردات وتراكيب عدد من لغات الشرق الأدنى القديم، أوحى إلى العلماء المهتمين بدراستها احتمالَ عودةِ هذه اللغات إلى لغة واحدة، وبالتالي إلى شعب واحد في يوم من الأيام، وَعَدّوا من تلك اللغات العربيةَ والعبريةَ والآرامية والكنعانية والبابلية والفينيقية والنبطية والحبشية، وأطلقوا عليها اسم (اللغات السامية)، وكان أول مَن أطلق عليها هذه التسمية العالم النمساوي (أوغست شلوتسر) عام 1781م، وشاعتِ التسميةُ لاحقاً في الإشارة إلى المجموعة اللغوية تلك.
وقد اعتمد (شلوتسر) في تلك التسمية على الإشارات التوراتية إلى قرابة تلك الشعوب ببعضها، وعودتها إلى جَدٍّ واحد هو سام بن نوح، إذ التوراة تجعل لنوح أبناءً ثلاثة هم: سام وحام ويافث.
وَيَرُوقُ لِكَثير من الباحثين اليوم أن يُطلقوا على تلك المجموعة اللغوية (اللغات الجَزَرية أو الجَزِيرية)، اعتراضاً على التسمية ذاتِ المرجع التوراتي التي لا تستند – بحسبهم – إلى أسس علمية أو عنصرية صحيحة، ولأن الموطنَ الأصلي للأمم السامية على الراجح من آراء العلماء هو الجزيرة العربية، وتحديداً الجزء الجنوبي الغربي منها، ومن الجزيرة العربية انطَلَقَتِ القبائلُ الساميةُ مُتَّجِهَةً إلى بلاد الرافدين وبلاد الشام وغيرها، واختلطتْ بغيرها من الأمم، وتغيَّرَتْ بيئَتُها، وَأَنشأَتْ حضاراتٍ راقيةً، وقد ساهَمَ كُلُّ هذا في اكتسابِ لغةِ تلك القبائل – السامية الجزرية – مفرداتٍ جديدةً فرضتها تلك الظروفُ البيئية والتاريخية والحضارية، كما أَدَّى إلى تَغَيُّرِ واندِثارِ مفرداتٍ من اللغة الأم، مما جعل من العربية – التي بَقِيَ أهلُها في موطنهم الأصلي – أَقْرَبَ اللغات السامية وأوثَقَها صِلَةً بِاللغة الأم، وَأَكَّدَ هذا القربَ ما امتازتْ به اللغةُ العربية عن بقية اللغات السامية من ظَوَاهِرَ وخَصَائصَ لغويةٍ غائبة أو مبتورَةٍ في كثير منها، كتكامل الحروف الهجائية والثراء في الصِّيَغ الاشتقاقية والظاهرة القديمة للإعراب.
عَرَبِيٌّ مُبين :
بَعدَ هذا الاكتشاف العلمي للمجموعة السامية، وَبَعدَ تَبَيُّنِ أَصَالَةِ اللغة العربية عامةً وَسَلامتها من التَّهجِين إلاَّ فيما نَدَرَ وَشَذّ، فضلاً عن عربية القرآن خاصةً، الذي أَكَّد الحقُّ بأنه نزل “بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ” الشعراء(195)، أي صُراح لم يُشَبْ بشائبة عُجْمَةٍ أو تعريب، ولا يقبل حتَّى الخلافَ حولَ براءته من ذلك، ولأنه لو كان فيه ما يَطعنُ في عَرَبِيَّتِه أو يخدشها – من أعجميِّ الألفاظ أو مُعَرَّبِها – لاتَّخذ المشركون ذلك حُجَّةً وذريعةً ومنقصةً، كان لذلك “قُرآناً عَرَبِيّاً غَيرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ” الزمر(28).
بعد هذا كُلِّه، لا شَكَّ أننا نقف على فصل جديد من فصول الإعجاز العلمي للقرآن الذي لا تنفد عجائبُه، ولا تنطفئ جَذوتُه، ولا تبلى جِدَّتُه، على مَرِّ الدُّهور، وانقضاء العصور.
الباحث / محمد عبد الكريم النعيمي* – المدينة المنورة/عضوءرابطة ادباء الشام
//انتهى/ادارة تحرير صوت النرويج/